
77
0
الرياض_فرقد تستضيف هيئة الأدب والنشر والترجمة، سلطنة عُمان الشقيقة كضيف شرف للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي سيقام تحت شعار "وجهة ملهمة" خلال …
12019
0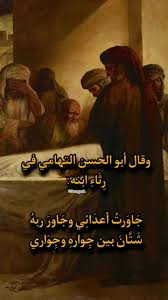
10922
0
10385
0
9266
5
7847
0
إعداد_حصة البوحيمد
تكتظ الكثير من القصائد والقصص والروايات بموجات الخذلان ووقائع النكران عبرالنصوص أو من خلال مصائر الشخصيات، الأمر الذي جعلها حاضرة بشكل كبير في الإبداع الأدبي؛ ما يثير الأسئلة في هذا الجانب: هل جاءت على سبيل الخيال لضرورة الكتابة وحتمية الصناعة الأدبية أم أنها ترسخت بفعل تجارب خاصة للمؤلف أم توظيف أدبي وإيحائي لمناقشة حقائق مجتمعية من خلال الأدب؟
فرقد تتبعت هذه الملامح في النتاج الأدبي من خلال طرح تساؤلاتها على نخبة من أهل الإبداع، ممثلة في المحاور التالية:
_ما مدى حضور الخذلان والنكران في الإنتاج الأدبي وما الأسباب والتداعيات لشيوع هذين المصطلحين وتبعاته في السياق المكتوب روائيًا أوقصصيًا أوشعريًا، في رأيك؟
– هل وجود الخذلان حالة خاصة بالمؤلف أم توظيف لمشهد مجتمعي، أم خيال واسع جاذب للقراءة والتحليل؟
– مع ارتفاع وتيرة التشاؤم والجوانب السلبية في الإنتاج الأدبي.. هل ترى ذلك صحيًّا لتوظيف المشاهد الدرامية، أم لابد من الموازنة بينها وبين الاتجاهات المبهجة؟
العمل الأدبي لا يقتصر على المثاليات

يستهل حوارنا القاص الأستاذ سعود آل سمرة معلقًا على محاور القضية:
يبدو لي أن الخذلان عندما يحضر كمصطلح في الروايات والقصص فهو ليس اختراعًا، ولم يكن من قبيل المصادفة أو مبالغة تم الزج بها، بل هو أحد المؤشرات الجدية على أن الكتابة السردية في بعض جوانبها انعكاس لبعض مشاعر الكاتب تجاه ملاحظاته وتجاربه في الحياة، التي لابد أن الخذلان عنصر مؤثر في أحداثها؛ فمثلًا ثمة شخصية قد تكون محورية في العمل السردي وتدور مجريات الأحداث ويتحرك الحدث وفق سلوكياتها فيه، وغالبًا هذا السلوك يطرأ نتيجة قلق ما، بينما أحد أسباب هذا القلق هو خذلان محتمل تعرض له من حبيبة أو خسارة مادية أو معنوية مباغتة، وهذه الأمور بوجه من الوجوه هي خذلان، فهو إن لم تخذله مخططاته التي كان يظنها متقنة وتفي بالغرض، فقد يكون خذله صديق خائن أو قريب لم يؤدِ ما عليه من التزامات أو حبيبة قررت شق طريقها في مكان آخر. وإذا تأملنا في كل هذي التصرفات وجدناها ليست مستغربة في سياقات الحياة، ويمكن أن نصنف كثيرًا منها إما في سياق النكران أو الخذلان أو الوفاء إن وجد، وبهذه الطريقة تحدث التحولات في حياة الشخصيات الطبيعية، ولابد أن يؤثث بمثلها أولئك الشخوص المصنوعين للعمل السردي حتى يؤدوا أدوارهم.. هذا على الأقل ما أظنه. وهذا الخذلان ليس شرطًا أن يتعلق بالمؤلف نفسه، فقد يكون نتيجة تجاربه في الحياة وملاحظاته ومعايشته أو استماعه لكل ما يدور حوله، فهو يتأثر بكل ما يدور حوله ولنا أستبعد أن له تجاربه الخاصة في الخذلان، فهذه الحياة ليست خالية ولكلٍّ تجربته وملاحظاته وقلقه الخاص.
أما عن التشاؤم الذي هو دائمًا المقابل الأول للتفاؤل، هو بنظري يأتي في الغالب محملًا بالنظرة السوداوية تجاه المستقبل عندما يبالغ الإنسان في لبس نظارة سوداء يرى من خلالها كل شيء.
لكن هناك مشكلة أيضًا بخصوص الكتابة وملمح التشاؤم الذي يظهر في بعض الأعمال، ثمة ما يمكن تفصيله بهذا الخصوص، فالعمل الأدبي قد لا يكون منصة مثالية للخير فقط، حتى نسبغه بشفافية التفاؤل والحب وينابيع الأرواح المتفائلة، هذا شيء لا وجود له إلا في المثاليات السطحية، أما إذا كان العمل الكتابي مسرح موازٍ للواقع كما يجب أن يكون العمل السردي، فلابد أن هناك صراعًا وهذا غالبًا لا يجري إلا بين اتجاهين متباينين أو ثنائيتين متقابلتين تتنازعان في الحدث لإحداث تحول ما، وغالبًا هما يمثلان الخير والشر، الحب والكراهية، الغنى والفقر، البراءة والنذالة، الحياة والموت، النور والظلام، الصدق والكذب، إلخ… هذه الثنائيات التي دائمًا نتيجة صراعها يجري تحول له ما بعده من مآلات، وجوهر الصراع إما نفسي أو مادي، وأحد هذه الثنائيات التي يتصارع ممثلوها يدفع باتجاه التفاؤل، بينما الآخر يهوي بممثليه نحو التشاؤم، وسنجد أنه كلما زادت نسبة استجابة الممثل للجاذب؛ ازدادت شدة المظهر في نفس الشخصية، وستكون نسبة التفاؤل أو التشاؤم علامة للاستجابة وملمحًا لأي مآل تذهب إليه النهاية، فالتفاؤل والتشاؤم وكذا من مثيلاتها هي مظاهر لأبعاد تفاعلية داخلية، جوانبه تظهر خافتة أو عالية الصوت بحسب ما يجري وما ينتهي إليه الصراع بين هذه الثنائيات.
المبدع معني بالواقعية وليس المثالية

وعن خيبات المبدع يتحدث الأديب صلاح بن هندي بقوله:
المثقف بطبعه يعيش في عالم مثالي يحاول به أن يرتقي بالواقع ومن فيه، لذلك تكون صدمته قوية حين لا يرى طموحه متحققًا في الواقع. هو يعيش ويكتب مستدعيًا ومستحضرًا الرموز والأسماء الثقافية التي سبقته، لذلك يشعر بالخذلان حين لا يحقق ما حققوه في زمانهم.
وكما قلت، المثقف والمبدع إنسان غير واقعي في أحايين كثيرة، لذلك يتبرم من واقعه مهما حصلت أصداء لكتاباته.
وعن ارتفاع وتيرة التشاؤم والجوانب السلبية في الإنتاج الأدبي، يقول الأستاذ محمد: ليس صحيًا أبدًا، على المثقف أن يتخلص من نفسية المصلح والواعظ، فهو معني بالواقعية وليس بالمثالية.
الكتابة دون التقاط الواقع جوفاء

وتؤكد الكاتبة شيماء الوطني من البحرين، على ضرورة تفاعل الكاتب مع واقعه سلبًا وإيجابًا، حيث قالت:
تقوم الروايات الناجحة على ركيزة، أن تبنى على أساس يتناول قضية معينة، وعلى ركيزة أخرى لا تقل أهمية وهي المشاعر والأحاسيس المنبثقة من النفس البشرية، وما الخذلان والنكران إلا شيء من تلك المشاعر الإنسانية التي قد تحدث لأيٍّ كان، ومتى ما شعر بها الكاتب وكان قادرًا على ترجمتها نثرًا أو شعرًا بشكل صريح وعميق فما الذي يمنع من ذلك، ومن خلال قراءاتي أجد أن الخذلان له حضوره القوي في النتاج الأدبي، ربما لشيوع مشاعر النكران والخذلان والخيبة في العلاقات الاجتماعية في الوقت الحاضر ولأسباب عدة منها المقارنات، الهشاشة، وتغير المفاهيم والقناعات الأخلاقية والدينية لدى الكثيرين، ولأسباب كثيرة يطول شرحها وليس هذا محلها!
ولدي قناعة خاصة من خلال قراءاتي أن الكاتب بشكل أو بآخر يقدم ما يعايشه بشكل شخصي، سواء كان حدث له أو لمن يعرف، بوعي منه أو نابع من لا وعيه، وليس في ذلك ضير أو عيب، فأصدق ما يُكتب، يُكتب عن دراية وعلم وإن غلب عليه الخيال. وكثير من الروايات التي قرأناها وتتحدث عن مشاعر وأحاسيس معينة مثل الخذلان، قد تعني وتمس الكاتب بشكلٍ خاص، حتى وإن أنكر ذلك، ولا تنفي هذه الحقيقة أن هناك من الكُتاب من يتعرضون لقصص الخذلان في رواياتهم من باب الواجب الاجتماعي والحس الأدبي ليس إلا…
النتاج الأدبي حصيلة ظواهر وقضايا مُلاحظة، لا يمكن تجاهلها في سياق الكتابة الأدبية، وإلا أصبح النتاج الأدبي مجرد كتابة جوفاء ومفرغة من المعنى والقيمة.
الكاتب يقدم ما يؤمن به وما يرصده قلمه من ملاحظات لا يمكنه تجاهلها بحجة إظهار الجوانب المبهجة، وفي رأيي أن الجوانب الإيجابية أو المبهجة لا يمكن طرحها في معزل عن طرح السلبيات، وإلا كان ذلك نوعًا من التهرب غير المبرر من مسئولية “الكلمة” والأهداف التي تُكتب من أجلها.
تقديم الواقع وقضاياه لا يحتاج بالضرورة إلى المبالغة والتعقيد، إنما يحتاج إلى الصراحة والصدق والشجاعة في الإقدام على كتابة ما يمكن أن يعرضك ككاتب إلى اتهامات التشاؤم والتحامل على أقل تقدير.
لا وجود لقضية وللكاتب حريته

ويرى الأديب والكاتب د.خالد الخضري أن للكاتب حريته في التعبير كما تملي عليه مشاهداته ومشاعره، حيث قال:
عفوًا، الموضوع نفسه لا يمثل مشكلة في الأعمال الإبداعية، أمر طبيعي أن يعبر الكاتب كما يريد، أين المشكلة في أن يعبر عن الخذلان بصفته أحد السلوكيات الإنسانية التي تحدث بين الناس.
وبالنسبة للسؤال ما مدى حضور الخذلان في الإنتاج الأدبي، لا نستطيع أن نحدد ما لم يكن هناك دراسة تحليلية، ترصد هذا الأمر في النصوص الإبداعية، بالذات في الرواية والقصة ويمكن أيضًا في النصوص الشعرية.
لكن السؤال يظل ملحًا، ما الفائدة وما النتيجة، وماذا سيستفسد الباحث أو الدارس أو حتى القارئ من معرفة ذلك، عندما يكتشف أن هناك نسبة عالية من توظيف الخذلان في الأعمال الإبداعية والأدبية، لأن الأمر كما ذكرت تحصيل حاصل.
فلا وجود لقضية أساسًا يمكن مناقشتها.
الانكسارات حمل ثقيل على الإبداع

ويفيد الأديب إبراهيم الحكيمي من اليمن، عن أسباب هذا التداعي المتشائم في النتاج الأدبي من وجهة نظره بقوله:
لطالما مثّل الجانب الأدبي والفكري والثقافي الجزء الأول والأساسي والمهم في أي مجتمع، كي يستطيع أن يبدأ خطواته نحو البناء. وهنا يلزم أن يكون هناك وعي كبير بالإنتاج الأدبي والفكري بشكل عام، لما يمكن أن يكون له من أثر، سواء سلبي أو إيجابي، على الحالة المادية والتنموية في أي بلد.
ولا يمكن التظاهر اليوم بعدم حضور الخذلان والنكران في الإنتاج الأدبي، فقد أصبح الأمر طاغيًا في أعمال كثيرة نالت حظًا من الشهرة. هناك عدد من الأسباب، التي قد تكون واقعية، أدت إلى الوصول إلى هذه النتيجة، منها الانكسارات المتتالية التي أصابت المجتمعات العربية، خاصة في العقود الأخيرة، ما شكّل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الحالة الإبداعية. ومع عدم توفر الإرشاد والدعم اللازم، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات، لتجاوز هذه الحالة والخروج من دائرة الذات، أصبح المشهد المليء بالقصص الموجعة حِملًا ثقيلًا على أصحابها. هكذا أصبحت الكتابة استجابةً لنداء عاطفي لحظي يمرّ به الكاتب، ليمارس ما يمكن أن يخفف به ما أثقل كاهله، كنوع من العلاج النفسي.
قد يكون من الأسباب أيضًا غياب دور النقد البنّاء المُوجِّه والمُعدِّل للبوصلة. وهذه البوصلة، واتجاهها برأيي، لا يجب أن تكون بحسب اتجاه الناقد الشخصي، بل حسب مصلحة البلد أو الأمة، وما ينبغي أن يكون عليه الهدف من تحفيز وتوجيه وترشيد الإنتاج الأدبي والفكري. الأمر بهذه البساطة: الدولة التي تريد أن تبنّي حضارة شامخة، لا بدّ أن تكون نخبها الفكرية والأدبية على مقدرة من إنتاج جيد، يعي كُتّابه نتائجه على القارئ.
والحقيقة أن هذه الحالة الشائعة من الخذلان والانكسار والانعزال في النتاج الأدبي متواجدة على عدة مستويات. يبدأ الأمر من الحالة المؤثرة في المشهد الجمعي، سواء كانت أزمات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أو ربما تأزم من أي نوع أو مستوى، وبشكل طبيعي لا بد أن يكون هناك انعكاس لمثل هذه الأزمات على الأفراد. ومن هنا يبدأ ثقل هذه الانعكاسات بالازدحام في المجال الفكري والإبداعي للأفراد. لذلك، فإن الكتابة تحت هذا النمط تصبح أمرًا إجباريًا، بل وتبدو طبيعية للكثيرين. وقد يُفسَّر هذا بما يحدث من أثر نفسي مريح يُجنى سريعًا عند الكتابة عن قضايا ذات بُعد عاطفي، سواء عند الفرد نفسه أو عند الجماعة. وهذه الأعمال، بطبيعة الحال –وقد يكون الأمر بدأ بشكل غير مقصود– جذبت اهتمامًا كبيرًا من القراء. وإن دلّ هذا على شيء، فإنما يدل على تلامس البُعد العاطفي في الأعمال بمختلف أنواعها مع شريحة واسعة من القراء. وهنا تكمن الإشكالية: فالانجذاب تجاه هذه الأعمال جاء مدفوعًا بحالة عاطفية، عادة ما يكون مخرجها تأكيدًا لحالة الخذلان المتواجدة أصلًا. وما يزيد هذه الإشكالية تعقيدًا هو التواصل العصري، الذي يتيح إعادة نشر هذه الأعمال كمحتوى بطرق مختلفة ومبسطة، ما يزيد من انتشار ما يمكن تشبيهه بـ(الوباء)، الذي يُكرّس حالة الخذلان عند شريحة أوسع من العامة، صانعًا بذلك حالة سلبية عامة تجاه الحياة، ويجرّ المجتمع بأسره إلى مزيد من التراجع، عوضًا عن التقدم.
بينما لو تم التعامل مع الواقع بوعي، لكانت النتيجة مختلفة. فمحاولة هضم الفكرة واستيعاب أبعادها، ومن ثم نقدها وإعادة تشكيلها بما يخدم تبديد حالة الانكسار عندأكبر قدر ممكن من الناس، بل ونشر قيم نفعية ووجدانية وزرع حافز على العمل والتقدم، يمكن أن يكون له أثر عظيم على المستوى الفردي والجماعي.
وختامًا، يمكن القول إن إعادة استهلاك المشاهد السلبية بصور مختلفة في الأعمال الأدبية قد يكون له أسبابه النفسية والمادية المحدودة، لكنه لا يعالج الجذور الأساسية للمشكلة، إنما يزيد من الفوضى. هنا لا ينبغي فهمي على أنني أعارض التعبير عن حالة واقعية سلبية، بل تكمن الرسالة في فهم أبعاد هذا الواقع وصياغته بطريقة مناسبة وإيجابية، يستطيع المتلقي من خلالها أن يشعر بأنه تم إنقاذه للتو من خطر كبير. هذا الخطر ليس بالضرورة أن يكون خارجيًا، بل قد يكون قريبًا كل القرب من كل شخص، وهو ذاته، وأفكاره، وتفسيره لواقعه المعاش. إن وجهة نظر إيجابية واحدة كفيلة بإعادة تشكيل إنسان كامل، ليُصبح مختلفًا وأكثر إنتاجًا في مجتمعه.
الفكرة إن تشكلت، يليها تحققها، فيلزم إذًا الحرص على تنقية الأفكار ونقدها وإعادة صياغتها بما يحقق الخير، ومن ثم يمكن نشرها.
هذه الإسقاطات خلدت ثراءً أدبيًا

ويشاركنا الحوار الأديب والقاص محمد الرياني، بقوله:
– الخذلان والنكران والحرمان معهما علامة فارقة في الأدب العربي، تحديدًا منذ القدم، ولو تأملنا هذا لوجدناه جليًّا وواضحًا في قصائد الغزل والفراق واللوعة والحنين والشوق، وساهمت هذه المشاعر بطريقة أو بأخرى في إثراء المشهد الأدبي، ولولا هذه الإسقاطات لما خلد لنا التاريخ قصصًا مشهورة؛ مثل عنتر وعبلة وقيس وليلى وغيرها، فتركت شعرًا ومشاعر خالدة؛ بل ونسجت منها أساطير وحكايات وتم تداولها على ألسنة العامة الذين حفظوا هذا التراث والثراء الأدبي، وهذه الإسقاطات وهذه المشاعر هي نتاج عادات وتقاليد ترسخت في أوساط القبائل لتجعل من النكران والخذلان سمة بارزة ساهمت في صنع مشاهد الخذلان والنكران.
وفي عصرنا الحاضر تبدو المسألة واضحة في الشعر الذي ترجم إلى أغنيات بألحان حزينة، أو أليمة تتوازى مع الحدث ولتكرس ثقافة هذا الخذلان.
ولأن المشاعر تتشابه في النفوس البشرية؛ فإن الخذلان والنكران يمتد إلى الأدب العالمي، حيث يصل الأمر إلى حالات الانتحار والقتل في صور شنيعة تغلبت فيها العاطفة السلبية على العقل والمنطق.
وما المؤلف إلا راصد لكل نبض في الحياة الاجتماعية، والأدب عمومًا هو ترجمة للأحداث مع إضافة الخيال الذي يتميز به الكاتب عن غيره، لذا فإن الحياة اليومية في المجتمعات تتدفق فيها تفاصيل كثيرة من حالات النكران والجحود والخذلان، سواء في المجتمع المدني المتحضر أو البعيد عن عالم الأضواء وبنسب متفاوتة، ولأن طبيعة النفس البشرية أشبه بالزجاج الشفاف؛ فإنها سريعة الانكسار والتهشم وقد تكون غير صالحة للعودة إلى وضعها الطبيعي، ومع هذا تتعامل بعض المجتمعات مع تلك المواقف بعقلانية فلا تسمح بمرور الخذلان أو لا تدع لآثاره بقاء، هنا لا بد أن نشير إلى أن الأدباء هم الأكثر تأثرًا؛ كونهم يمرون بتجارب عاطفية أو نفسية أو لأنهم ينظرون إلى الحياة بنرجسية فينشأ لديهم هذا الشعور، وفي المحصلة فإن أدب الخذلان وإن بدا في نظر القراء انعكاسًا سلبيًا، إلا أنه كتب تاريخًا أدبيًّا يستحق التوقف .
وأتفق تمامًا مع أن هذه الحالة وإن بدا في ظاهرها التشاؤم، إلا أنها أتاحت الفرصة لصناعة نوع من الأدب يحكي عن الشوق واللوعة والحرمان، والتاريخ منذ بدء التوثيق للأدب ترك روايات وقصصًا ومسرحيات وأساطير تحولت إلى أعمال درامية غزيرة، خاصة في الفترة الأخيرة التي تتسابق فيها محطات التلفزة العالمية إلى عمل نسخ درامية بلغات متعددة وبتحوير محدود لعمل روائي واحد وفكرته واحدة، ما يؤكد أن الخذلان والحرمان ثقافة واحدة؛ لأن طبيعة النفس البشرية تهزمها لغة الحب مثلًا، خاصة إذا شاب الحب حالات من النفور وعدم الوفاء.
ليس لنا أن نوجه مزاج الكاتب الإبداعي

ومن جهته يؤكد الأديب إبراهيم مضواح الألمعي على حرية اللحظة الإبداعية للكاتب، بقوله:
المأساةُ والملهاةُ مِن أبرز مظاهر الأدب، ويتفرَّع عن هذين الضربين ميولاتٌ فنيةٌ عدة، وتوظيفُ إحداهما فنيًّا نابعٌ من مِزَاج الكاتب، أو تجربته، أو مشاهداته، أو خيالاته، أو من اجتماع سببين أو أكثر منها؛ وبما أنها مستوفيةٌ للمقوماتِ الفَنيِّة، بِحَسبِ الشكل الذي تجلَّت فيه فليس لنا أن نُطالبَ الكاتبَ بتجنبها أو استبعادِها.
نعم؛ هناك من يَغلبُ على كتاباته الطابعُ المأساوي المتمثِّل في حالاتٍ من الخذلان، والجحود؛ وبما أن هذا هو مِزاجُه الإبداعي، فليس لنا أن نوجِّهه إلى التخلِّي عنه، برغمِ ما قَدْ يُشِيعُه بين قرائه من الشعورِ بالأسى، وزعزعةِ الثقة بالإنسان، وما قد يُقوِّضُ من قيمِ المروءةِ والنبل والوفاء، لكننا نملك أن نتجه في قراءاتنا إلى ما يُعلي مِن هذه القِيم، لدى كُتَّابٍ آخرين؛ وهذه طبيعة الحياة بوجهيها: الجميلِ والدميم، تنعكسُ على إنتاجِ المبدع؛ وفق زاويةِ رؤيتِه، وعُمقِ تجربته، وتأثير مِزاجه، ولكل اتجاه مُتَلَقُوُّه.
والآداب العربية والعالمية مليئة بالضَّربين، يُتلَقَيَانِ جنبًا إلى جنب، كما يحدثان في الحياة جنبًا إلى جنب، فنحن نقرأ أذكياء (ابن الجوزي)، وبخلاء (الجاحظ)، ونقرأ (أميلسيوران) الكافر بالإنسان، إلى جانب (جون سيتوارت مل) المؤمن به، ونقرأ جمال (أبوماضي)، إلى جانب ألم (الجواهري)، ونقرأ عبرات (المنفلوطي) ونظراته، على التوالي.
والغالب أن اللحظة الإبداعية لحظة شعورية دافقة يفرضها مِزاجُ الكاتب، ولا يملك توجيهها على نحو كامل.
الموازنة تخلق أدبًا أكثر تأثيرًا

وترى الكاتبة هاجر بوعبيد من المغرب، أن الواقعية المتوازنة هي روح الإبداع، بقولها:
الإنتاج الأدبي في كل عصر وجيل يعد مرآة واقعية لمجتمعه رغم الانصياع للخيال أو حتى مزجه بالواقع والخذلان والنكران، لصيقان في كل ظرف وزمان بحسب الظروف والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي قد تتوسع أو تضيق وحسب، أيضًا ما ذكر سابقًا، وبما أن الأدب وما ينجبه من قصص أو روايات أو خواطر يعكس تجارب الحياة الواقعية من طرف كتابها، ويعد الخذلان والنكران واقعًا ملموسًا بسبب التفاعل بينه وبين القراء ويعد أيضا جزءًا من الصراعات النفسية بين التجارب الاجتماعية المختلفة وبين عصر السرعة الذي يفشل فيه الإنسان الحديث في السيطرة على الوقت أو الحفاظ على النموذج الكلاسيكي للقراءة؛ ما يمثل صراعًا داخليًا أو خارجيًا وتأثيرًا دراميًا بين ما يُكتب وما يُقرأ وكيف وأين يُقرأ.
لكن علينا أيضًا أن ننتبه إلى أنه يمكن لهذا الخذلان والنكران والشعور المرافقان له أداة لخلق خيال واسع وجذاب للكتابة والقراءة والتحليل أيضًا، خاصة أن الرواية والقصة تستكشف العلاقات الإنسانية المعقدة وتفاعلها مع الأحداث بطرق مختلفة ومتنوعة، يمكن أن يخلق ذلك دراما وتشويق ينجذب القارئ له في ظل التوهان الذي يعيشه والكاتب، ما قد يجله سببًا رئيسيًا في التفاعل مع النص الأدبي.
في الختام، أعتقد أن الخذلان والنكران يمكن أن يكونا موضوعين مهمين في الأدب، خاصة إذا تم توظيفهما بطريقة تعكس الواقع المجتمعي وتخلق تواصلًا مع القراء. مع ذلك، من المهم الموازنة بين المشاهد الدرامية السلبية والإيجابية لخلق صورة شاملة ومتوازنة للواقع الإنساني. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق أعمال أدبية أكثر تأثيرًا وتواصلًا مع القراء.
الأدب مرآة لتجارب البشر المتباينة

وتشير الكاتبة مرضية الصحبي إلى ملامح هذه السمات في تاريخ الأدب العربي واستمراريتها، حيث أفادت:
مر الأدب العربي عبر العصور بمسيرة طويلة وشاقة، حيث تغنى الشعراء والكتاب قديمًا بكلمات نازفة من العاطفة، تناقلها العرب وتفاعلوا معها. تلك الكلمات دونتها العقول والقلوب، فتصدعت بها الصحاري، وآلمت من حُرم من بلوغ ما يتمنى.
وقد شهد التاريخ والأدب على هذه المسيرة، فكان هناك حالة استنكار لما يحدث لهذا الأدب. فالكتاب ظلوا يبحثون عن الأسباب وراء هذا الألم، وما الذنب الذي ارتكبوه ليتعرضوا له. البعض منهم ضاع في الجنون والهيام، ناطقًا بكلمات مدونة في الأدب.
ولم تكن ولادة هذا الأدب سهلة، بل مرت بمراحل صعبة، كانت انعكاسًا للحياة الواقعية التي كانت وما زالت. فالأدب هو تعبير عن تجارب البشر، من فرح وألم وخيبة. وقد مر الأدب بمراحل تطور عبر العقود، ليصل إلى الوضع الذي نراه اليوم.
في الماضي، كان الشعر والغزل يُتداول بين الناس، وقد وصلت إلينا أشعار امرئ القيس وجميل بثينة وعنترة. ورغم التشدد في وصف هذا الحب بأنه “عفيف”، فإنه كان تعبيرًا حقيقيًا عن مشاعر العشاق.
مع تطور الأدب، ظهرت الدراما والتلفزيون كوسائل جديدة للتعبير. فأصبح الكتاب يدونون قصصهم، ليعيش القراء معهم نفس الألم والغصة التي يخبرونها. وهذا أتاح لهم انتشارًا وشهرة أوسع.
ومع ذلك، لا يزال هناك من ينكر على الكُتَّاب التعبير عن السعادة، واتهامهم بالظلم والتزييف. فالبعض يرى أن التعبير عن الحزن هو الأصح، واعتبار السعادة أمرًا منكرًا.
لكن الحقيقة هي أن الحياة مليئة بالفرح والألم، وأن الأدب يعكس هذاالتنوع. فالإسلام قد هذب النفس البشرية وجعل للمتحابين اللقاء والزواج، وللفقد الرضا بقضاء الله. يقول الله تعالى في سورة هود: (إِلَّا الَّذينَ صَبَروا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولـئِكَ لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ كَبيرٌ).[٢]
وشواهد ذلك في شعر الخنساء والأبيات الشهيرة لأبي نواس. لذلك، لا ينبغي التجاهل لهذا النوع من الأدب، بل يجب أن نخرج من دائرة التباكي والخذلان. فالأدب هو تعبير عن حياة الإنسان، بكل ما فيها من فرح وألم. وعلينا أن نتقبل هذا التنوع ونستمتع به، بدلًا من محاولة إنكاره أو التلاعب بمشاعر الآخرين.
الواقعية قد تسقط الأوراق الصفراء

ويتحدث الأديب المصري عادل عمران من خلال فلسفته الخاصة حول ارتباط الإبداع بالواقعية وأثرها على التغيُّر الإيجابي، بقوله:
الكتابة الأدبية بمختلف ألوانها هي حالة للتعبير عن وجدان الكاتب ووجدان مجتمعه، يحاول فيها الكاتب إعادة رسم السياق بشكل يتوافق مع الضمير الإنساني والفطرة الإنسانية. الشعور بالخذلان من أكثر المشاعر التي تتأجج في ضميرنا الإنساني، فيأتي التعبير عنها في مقدمة تلك السياقات الأدبية التي يحاول فيها الكاتب تغيير واقعها ورسم واقع جديد لها.
في بحثي عن عملية تغيير الأوراق في النبات ومحاولة ربطها بالتعبير الأدبي الذي يحمله الكاتب عن مشاعر الخذلان والنكران ومحاولة التخلص منها كي يزهر من جديد ويزهر معه المجتمع، وجدت فوائد متعددة في عملية تغيير تلك الأوراق في النباتات أو ما يُسمى بمصطلح “التساقط” أو “الانفصال”، والتي تحدث خاصةً خلال فصل الخريف. خلال هذه العملية، يتغير لون الأوراق من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي، ثم تتساقط الأوراق. هذا التساقط يساعد النبات في توفير الطاقة والموارد، وحماية نفسه من البرد والجفاف، وتجديد نفسه ونمو أوراق جديدة.
إذا كان النبات يبحث عن هذا الإزهار والتجديد ومحاولة تغيير واقعه، فالأولى بالكاتب البحث عن هذا. لا إزهار جديد دون تساقط ودون انفصال، ولا انفصال دون تغيير واقع الخذلان. التعبير عن المشاعر الإنسانية مثل الألم والخيبة والغضب، والانتقاد الاجتماعي والبحث عن الهوية، والتأثير العاطفي، والتعبير عن الواقع، يمكن لكلّ ذلك أن يجعل الخذلان والنكران في الأدب تعبيرًا عن الواقع الاجتماعي والإنساني، ما يمكن أن يؤدي إلى فهم أعمق للتجربة الإنسانية، خاصة في ظل المادية العمياء التي تسود واقعنا الإنساني في ظل تزايد الحروب والصراعات بين البشر والبحث عن المصالح مهما كان ثمنها على الوجود الإنساني، وبغض الطرف عن مدى عدالة القضية التي تقوم هذه الصراعات من أجلها.
في النهاية، يمكنني القول إن واقعنا الأدبي لا بُدّ أن يعكس فيه الكاتب ذلك الواقع الاجتماعي والإنساني، ويمكن أن يكون التشاؤم والجوانب السلبية في الإنتاج الأدبي تعبيرًا عن المشاكل التي نواجهها جميعًا. ومع ذلك، من المهم أن يكون هناك توازن بين هذه الجوانب السلبية ونظيرتها الإيجابية. فإن تصوير الواقع بشكل أكثر دقة، مع تسليط الضوء على تلك المشاعر الإيجابية والسلبية، يمكن أن يلهم المجتمع للعمل نحو التغيير الإيجابي والتحسين من ضميره الإنساني، لعلّه ينظر إلى نفسه نظرة الفطرة الإنسانية التي خُلق عليها. ولعلّ تلك النظرة الواقعية تساعد في عملية تساقط تلك الأوراق الصفراء حتى نرى مجتمعاتنا الإنسانية تزهر من جديد.
التعليقات