
25
0
46
0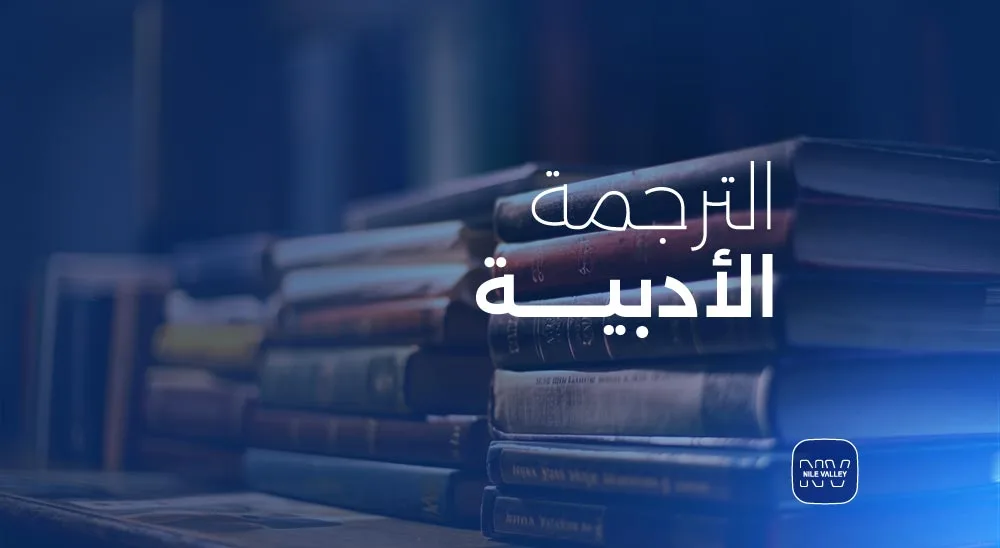
11
0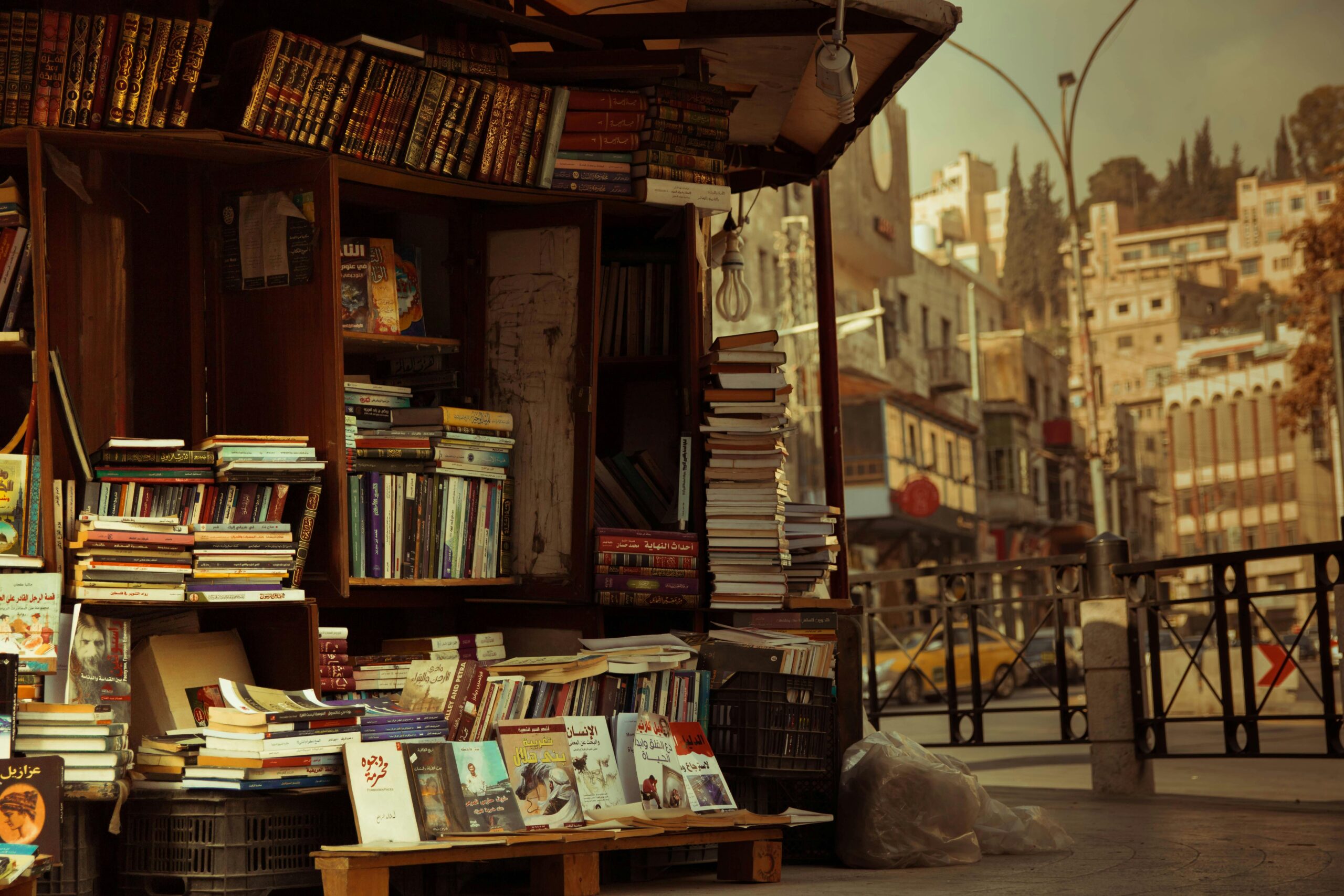
41
0
10
0
الرياض_فرقد تستضيف هيئة الأدب والنشر والترجمة، سلطنة عُمان الشقيقة كضيف شرف للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي سيقام تحت شعار "وجهة ملهمة" خلال …
12019
0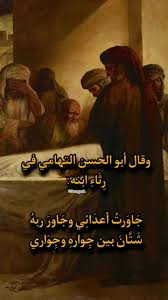
10970
0
10396
0
9283
5
7850
0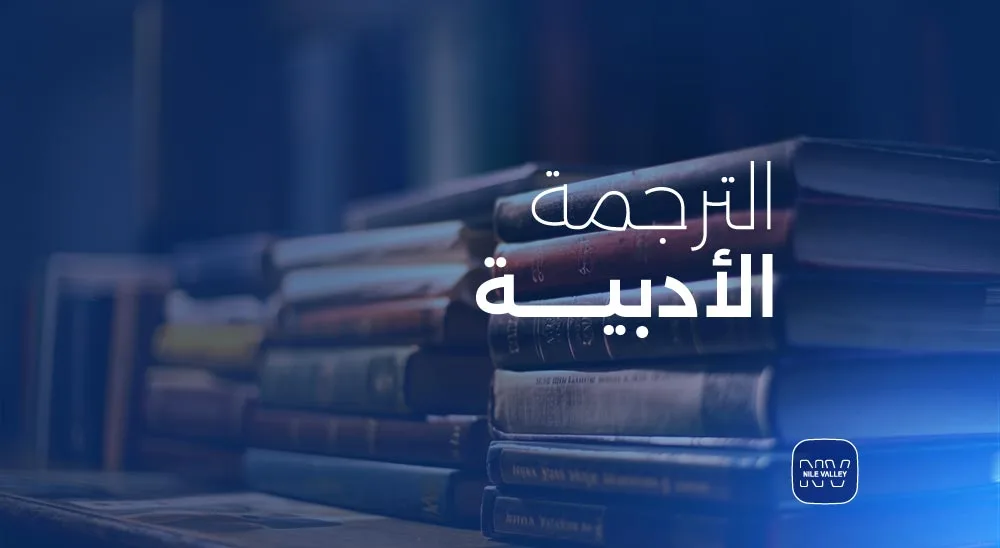
إعداد/ حصة البوحيمد
تُعد الترجمة الأدبية جسر الحضارات ونافذة العبور بين الشعوب، وهي التي حملت إلينا آداب الأمم وتجاربها، وأوصلت للعالم صوت أدبائنا وملامح أدبنا العربي.. غير أن هذا الجسر ليس سهلًا، فالمترجم الأدبي لا ينقل كلمات فحسب، بل يُمسك بروح النص وإيقاعه الجمالي والثقافي. هنا يبرز الجدل الأزلي: هل يلتزم المترجم بالأمانة الحرفية للنص أم يتصرف بحرية المبدع؟ وبين الوفاء والإبداع يبقى السؤال مطروحًا والجدل قائمًا.
فرقد الإبداعية.. سبرت أغوار هذه القضية من خلال طرح تساؤلاتها على نخبة من أصحاب الرؤى في المشهد الثقافي:
– ما الدور الذي لعبته الترجمة في انفتاح الأدب العربي على الآداب العالمية وتعريف الشعوب بثقافتنا؟ وهل يوجد نقد ممنهج لتحليل النصوص المترجمة وتقييم جودتها؟
– إلى أي مدى ينبغي للمترجم أن يبقى وفيًا للنص الأصلي؟ وهل الحرية في إعادة الصياغة تُعتبر خيانة للنص أم خدمة لجمالياته؟
– كيف يتعامل المترجم مع الإشارات الثقافية العميقة؛ كالأمثال والرموز التاريخية والمرجعيات التراثية التي قد لا يجد لها مقابلًا مباشرًا في اللغة المترجم إليها؟ وهل يؤدي ذلك إلى فقدان هوية النص المترجم؟
روح النص أحد أساسيات الترجمة

يبدأ حوارنا من العراق، المترجم عن اللغة الأسبانية حسين نهابة، بقوله: مؤكد أن الترجمات العربية إلى الإسبانية قليلة جدًا.. بل شحيحة مقارنة بالترجمات التي يقوم بها المترجمون العرب أو المستعربون، بنقل الثقافة العربية وآدابها إلى إسبانيا والدول الناطقة بها، ويعود ذلك إلى المشاريع الانفرادية التي يقوم بها مترجمون على حسابهم الخاص دون الحصول على دعم مؤسساتي يهيئ لهم الأجواء المناسبة لاحتضان هذه المشاريع، على الرغم من قيام بعض المؤسسات العربية ومنها مبادرة ترجم التابعة لهيئة الكتاب والترجمة لوزارة ثقافة المملكة العربية السعودية التي أخذت على عاتقها القيام بمهمة ترجمة الأدب السعودي إلى اللغة الأسبانية.. ومؤكد أن هناك بعض المؤسسات في العالم العربي تقوم بمثل تلك المهام.. لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
إن القارئ الأسباني يقوم بالطبع بتقييم ما يصل إلى يديه من تراجم متفرقة للأدب العربي، بالاعتماد على ذائقته القرائية أو النقدية التي يمتلكها، وأشعر أن القارئ الأسباني أو الناطق باللغة الأسبانية متلهف لتذوق كنوز الثقافة العربية.
إن المحافظة على روح النص هي أحد أساسيات المترجم المهني التي لا يمكن إغفالها مطلقًا.. وهناك ثلاثة أنواع للترجمة:
1. الحرفية 2. الدلالية 3. الأمينة
وهذه الأخيرة هي التي يلجأ اليها المترجم الخبير حتى يحافظ على روح النص.. إن وظيفة المترجم المهني أن يستوعب ثقافة وموروث اللغة الأصلية واللغة المنقول عنها، وفي كلتا الحالتين لا بد أن يواجه (أزمات ترجمية) في بعض الأحيان لعدم عثوره على كلمات قديمة أو كلمات محلية جدًا، ما يلزمه بالتصرف بها على ألا يخرج عن معناها الأصلي، أو أن يعثر على ما يقابلها في اللغة المُترجم إليها.. عندئذ، لا تعتبر الترجمة خروجًا عن النص إذا ما أجاد العثور على التعبير المناسب.
بقلة النقاد المتخصصين يستمر الخلل

ويشير الأديب والكاتب عبده الأسمري، إلى أهمية دور الترجمة في الانفتاح والعالمية، بقوله:
لقد لعبت الترجمة دورًا محوريًا في انفتاح الأدب العربي على الثقافة العالمية وأسهمت في نقل الصورة “المعرفية“ عن الثقافة العربية إلى العالم أجمع؛ ما أسهم في تعزيز الدور العربي الأدبي وتحفيز المترجمين على نقل الواقع الثقافي من خلال الإنتاج الأدبي الكبير إلى شتى أصقاع الأرض.
ويأتي الأمر في اتجاهات متوازنة ويسهم في جودة الإنتاج الأدبي، الذي تم نقل الصورة عنه وترجمته للشعوب عبر العالم لأكثر من لغة.
أما فيما يخض الترجمة وعلاقتها المجودة بتحليل النصوص.. فلا يزال هناك خلل أثر على مستوى الإتقان في الترجمة؛ نظرًا لقلة النقاد المتخصصين في هذا الجانب، كذلك عدم اهتمام الجامعات عبر الأكاديميين المتخصصين فيها، من وضع برامج تطويرية في هذا الجانب وندرة وجود ورش عمل تتعلق بنقد التراجم وما تشمله من تخصصات دقيقة.. إضافة إلى تباعد التعاون المعرفي الدولي في هذا الجانب، والذي يتطلب وجود ندوات على مستوى دولي ومناقشة الأخطاء ورصد التحديات ووضع سبل تعاون كفيلة بتجاوز العوائق في هذا المجال، مع ضرورة اهتمام الجهات الثقافية برصد الجانب النقدي وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على منجزات الترجمة للإنتاج، دون الخوض في تفاصيل الأخطاء المتواجدة داخل النصوص.. والوفاء للنص جزء من منظومة الاحترافية في الترجمة ولا بد من وجود مسارات للحرية في إعادة النصوص؛ نظرًا لأهمية تعديل بعض المصطلحات العميقة أو النادرة لتبسيط مفاهيمها للمتلقي، وهذه من الجزئيات المهمة.. التي يجب أن تكون من ضمن اتجاهات النقد، بل إن خيانة النص قد تكون في الترجمة الحرفية الناقلة التي قد تسهم في جمود النص نظير تغير المفاهيم، مع أهمية وجود التبسيط والشرح من خلال “الحاشية“ المتاحة في صفحات الكتب والتي تعد ركنًا من أركان احترافية التأليف.
وكما أسلفت.. هنالك إمكانية الشرح والتوضيح مع ضرورة التبسيط والبحث والتحليل دون الإخلال بجودة النص وهدفه ومعناه الرئيسي، مع ضرورة وضع برامج تعريفية وتثقيفية توضيحية.. من خلال الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تناقش الارتقاء بحرفة الترجمة وذائقتها الأدبية وأهدافها ومستقبلها المشرق.
المبالغة في إعادة الصياغة تلغي فكرة المؤلف
وتؤكد د. عفت جميل خوقير، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة أم القرى، ومؤلفة كثير من المؤلفات والأبحاث، منها ما يخص النقد والترجمة، على ازدهار الترجمة ووجود النقد الممنهج لها، بقولها:
حركة الترجمة في ازدياد ملحوظ؛ ما أدى إلى انفتاح الأدب العربي على الآداب العالمية، وتعريف العالم بثقافتنا وحضارتنا العربية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والصور النمطية عن العرب.. ومن خلال الترجمة يعبر الفكر العربي والأدب، والفن، والرؤية الإنسانية إلى اللغات الأخرى لتحقيق الفهم الأعمق على مستوى العالم، ويحقق الحضور العربي في المحافل الدولية، وبالمقابل تتاح للقارئ العربي فرصة الاطلاع على تجارب الآخر ومدارسه الفكرية المختلفة؛ ما يؤدي إلى التأثير والإثراء المتبادل.
وهناك نقد ممنهج في تحليل وتقييم جودة الترجمات، ويتجلى في:
1. قد يجري بعض القراء والنقاد الأدبيين قراءات للترجمات إلى العربية أو منها، ويشيرون إلى نقاط القوة والضعف فيها، من حيث الأمانة مع النص الأصلي أو الأسلوب، أو سوء الفهم الثقافي.
2. يوجد كثير من المراكز البحثية والمجلات العلمية المتخصصة في دراسات الترجمة ونقدها وتحليلها.
3. هناك الكثير من المؤلفات عن النظريات النقدية للترجمة، وأذكر على سبيل المثال مؤلفات الأستاذ الدكتور حسن غزالة، أحد أعلام الترجمة في الوطن العربي.
وينبغي أن يكون المترجم وفيًا للنص الأصلي قدر الإمكان، مع المحافظة على جماليات النص والمغزى الأساسي للمؤلف والمعاني الدلالية والثقافية، والابتعاد عن الترجمة الحرفية.
ويجب أن تكون حرية محدودة تخدم جماليات النص الأدبي وتنقل روحه بشكل أوضح، وألا يبالغ المترجم في إعادة الصياغة بشكل يلغي فكرة المؤلف أو يطمس المعالم الأساسية للنص الأصلي، أو يفرض وجهة نظره الشخصية.
ومن التحديات التي تواجه المترجم: الإشارات الثقافية العميقة؛ كالأمثال والرموز التاريخية والمرجعيات التراثية التي قد لا يجد لها مقابلًا مباشرًا في اللغة المترجم إليها، فالتعامل معها يكون بطرق تختلف حسب نوع النص، وجمهور القارئ، وهدف الترجمة: فلشرح مرجعية ثقافية أو مثل شعبي أو رمز، يضيف المترجم شرحًا داخل النص لتوضيح المقصود. Explicitation، أو يستخدم الهوامش أو الحواشي سواء في أسفل الصفحة أو في نهاية الكتاب (footnotes, endnotes)، أو يعد قائمة بالمفردات ومعانيها (glossary)، وللإبقاء على الخصائص الثقافية واللغوية للنص يمكن استعمال الغريب (Foreignization) فتكون الترجمة حرفية نوعًا ما، أما في استعمال طريقة التوطين (localization),، أو إيجاد البديل المعادل ثقافيًا (Cultural Substitution) ليفهم المعنى لدى المتلقي، وهناك إشكالية أكثر من لهجة محلية في اللغة الواحدة، فيلجأ المترجم إلى التواصل مع المؤلف لفهم المعنى، وهذا ما واجهته في ترجمتي الرواية (نساء البخور) للأديب خالد اليوسف.
وهل يؤدي ذلك إلى فقدان هوية النص المترجم؟ ليس بالضرورة، عندما يكون المترجم واعيًا ثقافيًا وأدبيًا.
الإشارات تمنح النص هويته الثقافية

وترى الأكاديمية نادية عبدالوهاب خوندنة، كاتبة ومترجمة أدبية معتمدة من هيئة الأدب، ضرورة الموازنة بين الحرفية والحرية رغم صعوبتها، حيث أفادت: هي في الحقيقة معادلة صعبة في بعض الأحيان، حيث إن المترجم يبذل قصارى جهده ويسخر تجربته الإبداعية في البقاء وفيًا للنص وروحه وجمالياته وأسلوب كاتب النص الأصلي وخصائصه المميزة، وفي الوقت نفسه يريد للنص أن يصل للمتلقي في اللغة والهدف كما لو كان قد كتب أصلًا بهذه اللغة، وقد يضطر المترجم أحيانًا -ولا يكون ذلك خيانة للنص- إلى إيجاد بعض الصيغ المكافئة والبديلة في اللغة الهدف التي تساعد في خلق ترجمة إبداعية للنص.
هذه الإشارات الثقافية من أبرز صعوبات الترجمة، لكن يستطيع المترجم المتمكن إيصالها للمتلقي، فهي من أكثر الخصائص الأسلوبية التي تمنح النص الأصلي هويته الثقافية الأصيلة، وذلك من خلال استخدامه لعدة تقنيات معينة مثل transliteration وذلك بكتابة الكلمة بالحروف اللاتينية وبخط مائل، ويمكن شرح الكلمة أو الأمثال أو المرجع التراثي في الهوامش، وذلك لأهميتها للنص الأصلي.
الترجمة من العربية لا تزال في ركود

وتقول الأستاذة لنا طه العوض من السودان، وهي مترجمة ومهتمة بالآداب والعلوم الإنسانية الناطقة بالإسبانية، تعليقًا على محاور القضية: تعرف الترجمة على أنها نقل نص من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الدلالات اللغوية والمعاني التعبيرية للكلمات عند تفسيرها في اللغة المنقولة إليها، لكن معنى الترجمة في التاريخ الإنساني هو كسر الحواجز بين الثقافات وانتفاء الحدود بين القارات واختزال العالم في قرية صغيرة من الشعوب، الترجمة في التاريخ الإنساني فعل قديم قدم الزمان نفسه منذ أن أدرك الإنسان أنه في حاجة للعيش في جماعات، فابتكر اللغة التي هي في الأصل نقل للعواطف والأفكار إلى كلمات وجمل ومسميات، وجاء اهتمام العرب بالترجمة من زمن قديم كانت تسافر فيه القوافل التجارية مشارق الأرض ومغاربها، فأصبح التواصل مع الآخر ضرورة تتطلب ترجمانًا يتكلم لغة الآخر بجانب العربية.
توسع لاحقًا اهتمام العرب بالترجمة مع توسع رقعة الإسلام.. فكانت أول دور الترجمة والنشر “بيت الحكمة” الذي أنشأه الخليفة هارون الرشيد الذي ترجمت في حناياه كتب الفلسفة والفن والأدب الإغريغي واللاتيني، وترجمت لاحقًا من العربية إلى كل لغات الدنيا، نشطت أيضًا حركة الترجمة من الآداب والعلوم العربية والتعاليم الإسلامية إلى الشعوب واللغات الأخرى في عهد الرشيد وما تلاه من عهود، فكانت الجسر المتين الذي ربط اللغة العربية وشعوبها وتراثها بكل الدنيا وقربها من كل أهل الأرض، وتغيرت حركة الترجمة في العالم العربي في عصرنا الحالي مع تغير الأدوات وتوازنات القوى العالمية، فسيطرت اللغة الانجليزية على علوم العالم وأدواته وأصبح التعامل بها وتعلمها ضرورة ملحة، وتبعًا لذلك طغت الترجمات من الإنجليزية إلى العربية على أغلب مجالات الحياة وعلومها وأعمالها، فنشطت حركة الترجمة من الإنجليزية، ويأتي في الترتيب بعدها الفرنسية والألمانية والروسية على الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى.. فبقيت صورة العرب في أذهان الآخرين عالقة في حكايات ألف ليلة وليلة، والإسلام ظل على تفسيراته الأولى كأن الزمن توقف بالثقافة العربية والإنسان العربي عند عصر الرشيد وما تلاه من عصور قريبة، ولم يفلح حتى فوز نجيب محفوظ بنوبل للآداب في تحديث صورة العرب عند الآخرين، ولا تزال حتى لحظة كتابتي لهذا المقال ومن وجهة نظر شخصي الضعيف، هناك إشكالية حقيقية وركود في حركة الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، وهذه الإشكالية تعود إلى أسباب كثيرة.. أهمها توقف البحث العلمي المكتوب باللغة والمفضي إلى اكتشافات عظيمة والتوترات السياسية من حروب ونزاعات التي عرقلة مسيرة العلم والفنون و الآداب بمختلف أنواعها.
على الرغم من أن حركة الترجمة والنشر لم تتوقف يومًا في العالم العربي من اللغات الأخرى إلى العربية.. بل إنها ازدهرت أكثر مع موجات اللجوء بعد الحروب وتعلم الكثير من اللاجئين العرب للغات البلدان التي نزحوا إليها، المئات والمئات من المترجمين والمترجمات الذين نقلوا وينقلون بشكل يومي إلى المكتبة العربية روائع الآداب العالمية والأبحاث العلمية والمقالات الإنسانية، لكن في المقابل هناك حذر متهيب من المترجمين العرب في ترجمة الروايات والقصص المعاصرة إلى اللغات التي يجيدونها، حتى أولئك المقيمون منهم منذ زمن طويل في البلد الناطق باللغة ويتكلمونها كما يتكلمون العربية.
وتتعدد أسباب هذا الحذر التي من ضمنها الأسباب التي قللت الاهتمام بالترجمة بشكل عام من العربية إلى اللغات الأخرى، هناك سبب آخر لركود وقلة ترجمة الرواية والقصة العربية الأول؛ هو القيود الاجتماعية والدينية والسياسية المفروضة على القصة العربية، التي منعت عن الرواية العربية الكثير من الحوارات الفكرية والنقاشات في القضايا المجتمعية والسياسية وأخرتها عن الحرية المطلقة التي تتمتع بها الرواية والقصة بهذا العصر في غيرها من اللغات، بالتالي أصبحت الرواية العربية غير جاذبة للقارئ الآخر وغير مرغوبة في سوق الترجمة، في رأيي هذه الأسباب هي نفسها التي جعلت من صورة العرب في أذهان الغير عالقة في العصر الذهبي للترجمة عصر هارون الرشيد والثراء الفاحش والسلطان والحريم، ومن تجربتي الشخصية كمترجمة محبة وهاوية لترجمة الشعر والقصص من اللغة الإسبانية إلى العربية، فأنا أؤمن بالأمانة في نقل الكلمات ومعانيها في الجمل الشعرية دون تدخل يذكر مني، فلا أترجم شعرًا لم أفهم كامل معناه ولا كل دلالاته ولا أُترجم لشاعر لا أعرف شيئًا عن حياته الشخصية وبيئته الاجتماعية وانتمائه السياسي، فهذا العمق من المعرفة بالشاعر أو القاص أو الكاتب يقدم تفسيرًا إضافيًا للتفسير الحرفي لمعاني ومقاصد الكلمات في الجمل الشعرية، ويجنبني الوقوع في فخ ركاكة الترجمة الحرفية والحاجة إلى تغيير الكلمات للوصول إلى المعنى المقصود في النص الأصلي.. الترجمة عندي تعلم مستمر لعادات وتاريخ الشعوب وسياساتها ومجتمعاتها وغوص في الحياة الشخصية للشاعر وتجول في أفكاره وآرائه، وأرى أن الترجمة تثري اللغة العربية وتزيد من مرونتها وانفتاحها على الشعوب الأخرى.. فلا أتحرج من نقل الأمثلة الشعبية كما هى ولا أجد غضاضة في نقل الجمل التعبيرية الخاصة باللغة الإسبانية إلى العربية؛ كإضافة تساهم في توسيع تعبيرات اللغة العربية وفتح آفاق كلامية جديدة إليها، ويمكن حل غموض التعبير في النص الأصلي الذي يشير إلى أحداث سياسية وتاريخية غير معروفة للقارئ بالهوامش المفسرة والشارحة على نهاية الصفحة، ولا تعارض أبدًا بين الأمانة في نقل النصوص الشعرية من اللغة الإسبانية وخروج النص بشكل جمالي يحرك العقل ويشعل العاطفة، فالشعر يخاطب ويصل الوجدان في كل اللغات.. المهم والنقطة الفارقة الفهم الجيد للنص الذي يأتي من الدراسة المتعمقة لحياة الشاعر ومجتمعه.
لا أمنح نفسي كَمترجمة الحق ولا الحرية في إعادة صياغة النص الشعري ليتناسب مع مجتمعي على حسب وجهة نظري، وأرى أن إعادة الصياغة خيانة للنص، ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تخدم جماليات النص الأصلي، فالنص الأصلي جميل كما كتبه وارتآه الشاعر.
الترجمة المبدعة إعادة خلق فني للنص في لغة أخرى

يشاركنا الحوار من مصر المترجم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف وفا، بقوله:
ﻟﻌﺒﺖ الترﺟﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ دورًا ﻣﺤﻮريًا في اﻧﻔﺘﺎح اﻷدب اﻟﻌﺮبي ﻋلى اﻵداب اﻟﻌﺎلمية، إذ كانت ﺟﺴﺮًا ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎفي والمعرفي، ﻧﻘﻠﺖ إلى اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌربي ﺗﺠﺎرب إنساﻧﻴﺔ وﻓﻜﺮية ﺛﺮية.. بالمقابل ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻋﻦ أدﺑﻨﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ، ﻓﻌرَّﻓﺖ الآخر بعمق ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ وﺛﺮاء ﻟﻐﺘﻨﺎ وﺟﻤﺎل تعبيرنا.. أﻣﺎ وﻓﺎء المترجم ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺻلي، فهو وﻓﺎء ﻟﻠﺮوح ﻻ للحرف؛ ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﺪ الحرفي ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻨﺺ ﻧﺒضه وﺣﻴويته، بينما ﺗﻤﻨﺢ ﺣرية اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ المترجم ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻔﻆ ﺟﻮهر المعنى وﺗبرز ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻷﺳﻠﻮب. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻓﺎﻟترﺟﻤﺔ المبدعة ﻻ تعد ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﺺ، بل هي إعادة خلق فني له في لغة أخرى.
ﻓﻌلى ﺳﻴﻞ المثال، حين ﻧترجم رواﻳﺔ ﻣﻦ اﻷدب اﻹنجليزي إلى اﻟﻌربية، ﻗﺪ ﻧﺠﺪ في اﻟﻨﺺ أن اﻟﺒﻄﻞ يشرب الخمر، وهنا ﻻ ﻳصح ﻧﻘلها ﺣﺮﻓيًا ﻷنها ﺗﻨﺎفي ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻟﺪﻳنية، ﻓيستعاض ﻋنها ﺑﺘﻌبير ﻳﻮﺻﻞ المعنى دون ﻣﺴﺎس ﺑﺎلمعتقد، كأن ﻧﻘﻮل كان البطل يحتسي عصيرًا.
كذلك عند ذكر الشريكين رﺟﻞ واﻣﺮأة يعيشان دون زواج، تترجم إلى “اﻟﺰوﺟين” ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋلى ﻟﻴﺎﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎق واﺣترامًا للقيم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻏير أن هذه الحرية ﻻ ﻣﺠﺎل لها في ﻣﺠﺎﻻت الترجمة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ كاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ الترجمة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ الإلمام اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ، وﻟﻮ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺳﺒﺎبًا أو ﻗﺬفًا، لأنها تمس ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﻷﺣكام اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.. ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺒﻴﺔ، إذ لا يسمح ﺑﺄي ﺗﺤﻮير أو اجتهاد في المعنى أو المصطلحات لما ﻗﺪ ﻳترتب على ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر صحية ﺧﻄيرة، وفي ﻣﻮاجهة اﻹﺷﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ يظهر المترجم وعيه الفني وبصيرته اﻟﻠﻐﻮية ﻓﻴﻮازن ﺑين اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ، ﻣﺤﺎﻓﻈًﺎ على هوية اﻟﻨﺺ وروحه ﻗﺪر اﻹﻣكان. فالمهارة الحقيقية ﺗﻜﻤﻦ أن يشعر اﻟﻘﺎرئ ﺑﺠﻤﺎل اﻷﺻﻞ دون أن ﻳﻔﻘﺪ وﺿﻮح المعنى في لغته.. وهنا تتجلى عبقرية المترجم ﺑﻮصفه ﺟﺴﺮًا ﻧﺎبضًا ﺑين عالمين ﻻ ﻳﻨﻘﻞ اﻟكلمات فحسب، ﺑﻞ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻮجدان والفكر والروح.
الخيانة الشكلية أحيانًا نوع من الوفاء

ويفيدنا الأديب والمترجم خلف سرحان القرشي بوجهة نظره حول القضية المطروحة، بقوله: الترجمة ليست بوابة لغوية فحسب، بل نافذة روحية يرى الأدب العربي من خلالها نفسه في مرآة العالم.. لقد منحتنا الترجمة فرصة ثمينة لنتعرّف على تجارب إنسانية عميقة، وأنماط سرد وأساليب فكرية مختلفة، أسهمت في تطوير الذائقة الأدبية العربية وتوسيع آفاقها. ومن خلالها أيضًا، تعرّفت الشعوب الأخرى على نبضنا الثقافي، وعلى غنى المخزون الرمزي والإنساني في أدبنا.
ومن خلال تجربتي في ترجمة عشرات القصص القصيرة والمقالات الأدبية وبعض القصائد، أستطيع القول إن الترجمة ليست مجرد وسيلة للنقل، بل عملية تلاقح ثقافي تفرز فكرًا جديدًا على الطرفين.. أما النقد الموجّه للنصوص المترجمة فما زال محدودًا في العالم العربي؛ إذ يندر وجود مؤسسات نقدية تتناول النص المترجم بوصفه عملًا أدبيًا قائمًا بذاته يحتاج إلى قراءة مزدوجة: قراءة للنص الأصلي وقراءة لروحه في لغته الجديدة.
والوفاء للنص لا يعني الترجمة الحرفية، كما أن الحرية لا تعني الانفلات. المترجم المبدع هو من يحافظ على حرارة النص الأصلية وهو يعيد ولادته في لغة أخرى. أحيانًا، تكون الخيانة الشكلية للنص نوعًا من الوفاء الجوهري له، حين تقتضي اللغة المستقبِلة تغيير الإيقاع أو الصورة لضمان الأثر ذاته في نفس القارئ.
وأنا شخصيًا أرى أن المترجم الذي يكتفي بالنقل الميكانيكي يخون الفن، أما الذي يتذوق النص فيُعيد كتابته بالوجدان ذاته، فهو يخدم جمالياته ويمنحه حياة ثانية.. الترجمة، في جوهرها، ليست نقلًا، بل إعادة خلق.
وعن التعامل مع الرموز والإشارات الثقافية يقول الأستاذ خلف: هنا تتجلّى أصعب لحظات المترجم.. الأمثال والرموز التاريخية والمرجعيات التراثية لا تُنقل حرفيًا دون أن تفقد نكهتها، ولا يمكن تجاهلها دون أن يُصاب النص بالعجز.. على المترجم أن يكون وسيطًا ثقافيًا ذكيًا، يشرح حين يلزم، ويومئ حين يغني الإيماء عن الشرح.. فحين أترجم مثلًا نصًا عربيًا يفيض بروائح الصحراء أو بإيقاع الدعاء، أبحث عما يعادله في الحس الغربي من مشاعر أو رموز دون أن أذيب خصوصية النص.
الترجمة الحقيقية تحافظ على هوية النص بقدر ما تُعرّف الآخر عليه، فهي جسرٌ يعبر عليه الاثنان دون أن يفقد أحدهما ملامحه.
أخيرًا، وبهذا المعنى، أرى أن الترجمة الأدبية ليست فنًا تابعًا، بل فنًا موازيًا للكتابة ذاتها؛ إذ تخلق عالمًا جديدًا، وتمنح النص حياة إضافية في زمن آخر ولغة أخرى، دون أن تنزع عنه جذوره.
الترجمة للأدب العربي عبور للعالمية

وترى الأديبة والمترجمة نيفين محيسن من فلسطين، أن الترجمة عبور وجدان إلى وجدان، حيث أفادت: كما هو معروف، فالترجمة هي موازنة دقيقة بين الوفاء للنص الأصلي والإبداع الفني للمترجم بشكل عام.. والأدبية منها -وهي الأصعب بالنسبة لي- ليست عبورًا من لغةٍ إلى أخرى فحسب، بل هي عبور وجدان إلى وجدان، ونقل نبض ومضمون نصٍ من قلب ثقافةٍ إلى قلب ثقافةٍ أخرى. لقد فتحت الترجمة للأدب العربي أبواب التعرف على العالم، فأطلَّ عبرها على تجارب إنسانية ثرية، واكتشف بأنها جسر عبره الآخرون للتعرّف على جمال لغتنا وأصالة وجداننا العربي.
هذا الجمال لا يكتمل دون عنصر النقد الواعي الذي يزن النصوص المترجمة بميزان المهنية والدقة، فيكشف أين أبدع المترجم وأين خانه التعبير في السياق.. فالمترجم الحقيقي لا يكون ظلًّا للنص، بل رفيقُ دربه؛ يحافظ عليه، لكنه في الوقت نفسه يمنحه حياةً جديدة في عالمٍ آخر.
وحين يصطدم المترجم بالإشارات الثقافية العميقة —كالأمثال والرموز التاريخية والمرجعيات التراثية — فإن موهبته تتجسد في قدرته على توصيل روح المعنى للنص الأصلي لا حرفه عن هدفه، ليظل النص مترجمًا دون أن يفقد هويته، ليعاد اكتشافه بلغةٍ جديدة مفعمة بالإحساس، وبذلك يكمن التحدي في تحقيق التوازن بين الالتزام بالنص الأصلي وإضفاء لمسة إبداعية، دون المساس بروح العمل.
المرجعيات الثقافية للنص.. مسؤولية على عاتق المترجم

وتشاركنا الرأي الأستاذة سحر خنجي معلمة ومترجمة ومتخصصة في الأدب الإنجليزي واللغويات والمسرح، بقولها:
الترجمة جسر لُغوي يربط بين الثقافات المختلفة حول العالم.. وكما انفتح العالم العربي على حضارات مختلفة من خلال الترجمة، اهتم العالم أيضًا بتراث الأدب العربي، فأتت الترجمة لتنقل المشهد الأدبي العربي على مدى التاريخ. وتُعتبر اللغة العربية بالتحديد من أكثر عشر لغات مترجمة حول العالم.
تلعب ترجمة الأدب العربي دورًا حاسمًا في تعزيز اللغة العربية من خلال طرح الأعمال الأدبية العربية بمختلف أنواعها للجمهور العالمي، وهنا يساعد مترجمو الأدب العربي في تعريف القراء بثقافة أدبية غنية بحضارتها وملهمة بثقافتها المتعددة.
أما نقد النصوص المترجمة، فهي عملية صعبة ومعقدة ومهمة في الوقت نفسه.. وتأتي أهميتها بأهمية ترجمة النصوص، هنا علينا أن نتوقف عند أهمية معرفة الناقد باللغة الأصلية للنص المترجم، حتى نأتي بنقد صحيح يلم بكل جوانب النص ونقده بمنهج المقارنة الصحيحة بين النص الأصلي والنص المترجم، وإلا سيكون النقد مقتصرًا على قراءة النص المترجم وسيقتصر الناقد في نقده على فكرة النص والتدقيق اللغوي للنص المترجم.. على المترجم الجيد ألا يقع في فخ الترجمة الحرفية للنص؛ لأن جمالية النص الأصلي لا يمكن أن تنتقل إلى لغة أخرى دون أن تتوافق مع جمالية هذه اللغة، هنا تظهر مهارة المترجم اللغوية والأدبية في نقل روح الكاتب وفكرته الأساسية في النص إلى القارئ بشكل صحيح، ولا تعتبر إعادة صياغة النص الأصلي خيانة للكاتب، شرط أن يحتفظ المترجم إلى حد ما بأسلوب الكاتب في طرح الفكرة.. هذه المسؤولية على قدر دقتها صعوبتها، إلا أن المترجم المتمرس يستطيع بخبرته وقدرته اللغوية في نقل النص الأصلي بكل جمالياته إلى نص آخر.
إلى جانب دور المترجم في نقل النص من لغة إلى أخرى.. تأتي المسؤولية الكبرى في نقل الإشارات الثقافية والتراثية التي طرحها الكاتب من خلال نصه، وذلك بنهج لغوي وأدبي يفهمه القارئ.. تكمن الصعوبة أحيانًا في عدم وجود مصطلحات لغوية في اللغة المترجمة قريبة من الإشارات الثقافية الخاصة باللغة الأصلية، وأنا ضد التخلي عن ترجمة الجوانب الثقافية عند صعوبة ترجمتها.. فلا بد من مخرج يعطينا إشارة للفكرة المطروحة، وإلا سيفتقد المتلقي جزءًا من هوية النص الأصلي، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المترجم في نقل هذه الحضارة والمرجعيات الثقافية التي تحكيها اللغة الأصلية وضرورة معرفته للخلفية الثقافية التي تناولها النص الأصلي تساعد كثيرًا في نجاح مهمته.
الترجمة فن ورسالة ينقل المترجم من خلالها نصًا بلغةٍ أخرى.. لكن أكبر تحدٍ هو نقل روح الكاتب وثقافته.
التعليقات