
50
0
298
1
164
0
35
0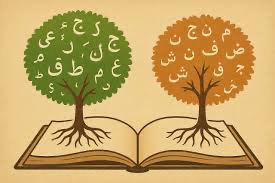
46
0
الرياض_فرقد تستضيف هيئة الأدب والنشر والترجمة، سلطنة عُمان الشقيقة كضيف شرف للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، والذي سيقام تحت شعار "وجهة ملهمة" خلال …
11991
0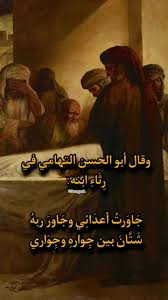
9699
0
9179
0
7402
5
6956
0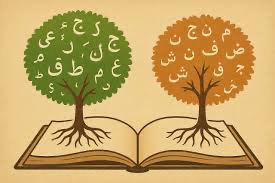
بقلم: زكية مصات*
انقسمت اللغة إلى عدة فصائل، ما أدى إلى تضارب آراء علماء اللغة حول الأسس المراعاة في هذا التقسيم. وتبقى نظرية “ماكس مولر” أهم هذه النظريات وأشهرها، وترى هذه النظرية بـأن اللغات يجب أن تقسم إلى فصائل تجمع بينهما صلة قرابة، بالتالي تتفق في أصول الكلمات وبنية الجملة وغير ذلك، وتؤلف بينها مجموعة من الروابط التاريخية والجغرافية والإنسانية والحضارية.
على هذا الأساس تُعيد نظرية ماكس مولر جميع اللغات الإنسانية إلى ثلاث فصائل: الطورانية، الهندو- أوربية، السامية؛ وهاتين الأخيرتين هما موضوع دراستنا.
وتشمل الفصيلة الهندو- أوربية ثمان طوائف من اللغات (الايرانية أو اللغات الآرية؛ وتعني اللغات السنسكريتية والبراكريتية، والهندية الحديثة، والفارسية القديمة، والأفستية، والزندافستية والبهلوية، والفارسية الحديثة، والكردية.) وتنقسم اللغات الهندية -الإيرانية بدورها إلى شعبتين: شعبة اللغات الهندية، وشعبة اللغات الإيرانية (الفارسية الحديثة…). ولكن العلماء عدّوا هاتين الشعبتين طائفة واحدة لكثرة التشابه بينهما وبين شعبة اللغات الأرمينية والإغريقية والإسبانية والإيطالية والكلتية والجرمانية والبلطيقية.
وتُعدّ اللغات الهندو – أوربية هي أكثر اللغات انتشارًا في العالم، إذ يتكلم بها معظم سكان أوربا وأمريكا وقسم كبير من آسيا (مثل الهند وفارس وأفغنستان). ويرجع الفضل في انتشار هذه الفصيلة إلى عدة أسباب، من أهمها الاستعمار: أنه قد تضاربت آراء العلماء حول الموطن الأول لهذه الفصيلة، فمنهم من قال إنها نشأت بأوربا الشرقية وبالتحديد روسيا، ومنهم من أرجع نشأتها إلى بحر البلطيق؛ وأنها تمتاز هذه الفصيلة بكثرة الاختلاف بين أفرادها وتضاؤل وجوه الشبه ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف البيئة والشؤون الاجتماعية لكل طائفة، فنتج عن ذلك اختلاف اللغات في درجة الرقي ومبلغ بعدها عن أصولها الأولى[1].
وأما الفصيلة الثانية (السامية الحامية) فتشمل مجموعتين: مجموعة اللغات السامية، وهي تضمّ السامية الشمالية وهي اللغات الأكاديمية (الأشورية البابلية) واللغات الكنغانية (العبرية والفنيقية) واللغات الآرامية والسامية الجنوبية: وهي العربية القديمة واللغات الحبشية السامية.
ومجموعة اللغات الحامية، وتنقسم إلى ثلاث طوائف: المصرية والليبية والكوشيكية، وتتفرع كل واحدة منها إلى عدة فروع…
إلا أن أهم ما يشدّ انتباهنا في هذا الموضوع هو المساحة التي تشغلها كل من الفصيلتين، حيث يتضح للمتتبع أن المنطقة التي تشغلها فصيلة اللغات السامية- الحامية أصغر بكثير من المنطقة التي تسودها اللغات الهندو-أروبية: فبينما تشغل الفصيلة الهندية- الأوريية أوربا والأمريكيتين واستراليا وجنوب أفريقيا وقسما كبيرا من آسيا، لا تشغل الفصيلة الحامية- السامية إلا بلاد العرب وشمال إفريقيا وجزءا من شرقيها (إلى درجة عرض 4 جنوب خط الاستواء). ولا تتجاوز منطقتها عشرين مليون كيلومترا مربعا، بها قسم كبير هو صحراوي (ببلدان العرب وشمال إفريقيا)، ويبلغ عدد الناطقين بها زهاء مائة مليون، لكنها تمتاز عن الفصيلة الهندية – الأوربية بان منطقتها متماسكة الأجزاء لا يتخللها أي عنصر أجنبي. ويتألف من الناطقين بها مجموعة شديدة التجانس تتلاءم شعوبها في أصول واحدة قريبة، وتتفق في أساليب الحياة ونوع الحضارة والنظم الاجتماعية[2].
ومما لا شك فيه أن الفصيلتين قد تختلفان في عدد من الخصائص، وقد استرعى انتباهنا من بينها أصول الكلمات على سبيل المثال لا الحصر، إذ تتألف أصول الكلمات في اللغات السامية في الغالب من ثلاثة أصوات ساكنة، بينما لا تتحد أصول الكلمات بين جميع لغات الفصيلة الهندو – أوربية، فمنها الثنائي ومنها الثلاثي والرباعي، زد على ذلك أن هذه الأصول ليست مؤلفة من أصوات ساكنة فقط، بل تختلط فيها الأصوات الساكنة باللينة.
وتعدّ اللغة العربية من أهمّ المواضيع التي كرّس لها العلماء والباحثون في اللغة قسطا غير قليل من البحث، وبالأخص علاقتها بلغات أخرى. ولعل اللغة الفارسية تحتل منزلة خاصة بين اللغات، لأنها تآلفت كثيرًا مع اللغة العربية[3].
فما مدى تلاقح اللغتين؟ وأيهما نهلت من الأخرى أكثر؟ وأيهما كان لها السبق في الاقتراض من الأخرى؟
سننطلق من افتراض أن اللغة العربية كانت أسبق للأخذ من الفارسية قبل الإسلام وفي ظله، إذ نجد الكثير من الألفاظ الفارسية في القرآن الكريم مثل سندس واستبرق وأباريق في الآيتين الكريمتين:
﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ[4]وَإِسْتَبْرَقٍ[5]﴾ [الكهف:31]
-﴿بِأَكْوَابٍ وأبَارٍيقَ[6] وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ [الواقعة/18].
لكن بعد فتح المسلمين لبلاد فارس ودخول الفرس إلى الدين الجديد، كان لا بد من أن يتعلموا لغة القرآن، ومن هنا بدأت اللغة الفارسية تتأثر باللغة العربية شيئًا فشيئًا إلى أن صار ذلك التأثير واضحًا. لكن بقي للفرس تأثير على العرب أيضًا حتى بعد ظهور الإسلام: فقد قدّم طه ندا في كتابه “الأدب المقارن” مثالين على ذلك، أولهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحير في إحصاء الغنائم التي كانت ترد عليه وكيفية توزيعها حتى أشار عليه واحد من الفرس بتدوين الدواوين، وكان هذا مبدأ اتخاذ الدواوين[7]، وثانيهما: أن الدولة الإسلامية الجديدة أرادت الاستفادة من خبرة الفرس المسلمين، فبقي الدهاقين[8] يؤدون خدماتهم للدولة الإسلامية، وقد كانت هذه الخدمات تنحصر في جمع الضرائب، وإمساك دفاترها، وتحديد الضريبة المفروضة على كل ممول؛ وهكذا فهم يمثلون الدولة في أقاليمهم، وقد دامت الدولة الإسلامية على هذه الحال مدة غير قصيرة، مما نتج عنه دخول عدد من المصطلحات الفارسية إلى اللغة العربية، لذلك سنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على التلاقح بين اللغتين، ثم النظر في مدى تأثير كل واحدة في الأخرى؟ وأيهما نهلت أكثر من الأخرى؟ وما عيوب اللسانين جراء التأثير والتأثر؟
١- تأثير العربية في الفارسية:
بعد انتشار اللغة العربية بين سكان إيران إثر الفتح الإسلامي، أصبح الإيرانيون يوظفونها في كتاباتهم الأدبية، وخصوصًا الشعر الذي أضحى لا يخلو من ألفاظ عربية على الرغم من محاولة الشعراء توخي استعمالها: ولعل “شاهنامة الفردوسي”، التي حاول صاحبها صياغتها في عبارات فارسية محضة، خير مثال على ذلك. وهناك من يرى أن “الشاهنامة” تتضمن حوالي ثمانمائة كلمة عربية[9].
ويوضح المستشرق “إدوار براون” هذا الأمر قائلا: ” لو أن أحدا أراد أن يكتب شيئا بالفارسية بحيث تكون كتابته خلوا من الألفاظ العربية لأعسر عليه الأمر، كما يتعسر على الذي يريد أن يكتب شيئًا بالإنجليزية، بحيث تكون كتابته خالية من كل كلمة يرجع اشتقاقها إلى أصل يوناني أو فرنسي، ولربما استطاع بعض الناس أن يفعلوا ذلك على نطاق ضيق، لكن كتاباتهم تظلّ عسيرة الفهم إذا لم يستعنْ القارئ على فهمها بمعجم من المعاجم اللغوية”[10]؛ وفي المقابل، لم تلقَ النصوص المكتوبة بعبارة فارسية محضة رواجًا، وذلك لخلوها من الألفاظ العربية، فقد كان لا بد من حضور العربية في الكتابات الفارسية، كما هو الحال مثلا عند “عنصر المعالي كيكاوس[11] ” في كتابه ” قابوسنامة”[12]، الذي ألَّفه سنة 475 ه ناصحًا ابنه كيلا نشاه: “… وزيّنْ رسالتك بالاستعارات والأمثال والآيات القرآنية والأخبار النبوية، وإذا كانت رسالتك بالفارسية فلا تكتبها بالفارسية الخالصة فإنها ليست مقبولة، وخاصة الفارسية الدرية، إذ إنها غير معروفة”[13].
ومن أول مظاهر التأثر باللغة العربية هي أن كثيرًا من الإيرانيين بدأوا يلقبون أنفسهم بألقاب عربية ويسمون أنفسهم بأسماء عربية، كما ظهرت العبارات العربية على عملاتهم ابتداء من 32 هجرية، وظهرت بعد ذلك أسماء خلفاء بني أمية على هذه العملات. وعلى الرغم من حثّ عميد الملك الكندري (الوزير السلجوقي) على كتابة الرسائل الفارسية، لكن هذه الرسائل لم تخلُ من الألفاظ العربية.
وهناك من العلماء الفرس من ألف بالفارسية فقط، ومنهم من ألف باللغتين معًا، مثل الطبيب الفيلسوف “أبو علي بن سينا”، فمن كتبه العربية مثلا: الشفاء والقانون، ومن كتبه الفارسية كتاب “دانشنامه علائي”[14]؛ بل وهناك أيضًا من ارتبطت شهرته بالكتابة العربية أكثر من الفارسية، ومنهم الصاحب بن عباد وعبد القاهر الجرجاني. ويرجع هذا الاهتمام بالعربية على حساب الفارسية إلى كون اللغة العربية هي الأولى من الناحية الأدبية والثقافية بصفة عامة، كما أنها أكثر قدرة على تأدية بعض الأغراض العلمية. وإذا نظرنا إلى العوامل التي ساعدت في دخول كثير من الألفاظ العربية إلى الفارسية سنجدها متعددة، وفي مقدمتها السبب الذي سبق ذكره، وهو أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، كما أن الإيرانيين وجدوا الألفاظ العربية أسهل بكثير من الألفاظ الفارسية، خصوصًا التي كانت تكتب بالخط البهلوي، ومن الأسباب المساعدة أيضا اهتمام الفرس بالمحسنات اللفظية التي تزخر بها اللغة العربية وتفتقر إليها اللغة الفارسية.
٢- تأثير الفارسية في العربية:
تحتلّ اللغة العربية مرتبة بين اللغات الأخرى تجعلها لا تنعزل عنها أو تبقى بعيدة عن التأثر بها، بل إنها متحت من كثير من اللغات، مثل اللغة الفارسية موضوع دراستنا، وقد كان ذلك قبل ظهور الإسلام بمدة غير قصيرة، فالعلاقات السياسية والتجارية التي كانت تربط بين العرب والفرس جعلت اللغة العربية تقترض[15] الكثير من الكلمات الفارسية مثل كلمة ( ورد) التي تطلق على الوردة الحمراء، والتي يظن أنها أخذت من كلمة (ورذ) في اللغة الأفستية، وغيرها كثير من الألفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل مثل إستبرق فهي معرب (استبرك) وإبريق وهي معرب (آب ريز)… إلخ.
إلا أن العلماء والفقهاء اختلفوا في حقيقة هذه الألفاظ، فقد ذكر الجواليقي أن بعضهم احتج بالآية الكريمةّ: “إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون” [سورة الزخرف الآية 3]، على أن كتاب الله ليس فيه شيء غير العربية؛ كما أن فيهم من ادعى أن بعض الكلمات مثل (سجيل والمشكاة) من لسان غير عربي، بيد أن الجواليقي جمع بين الرأيين، فرأى أن هذه الحروف كانت من لسان غير عربي في الأصل ثم لفظتها العرب بألسنتها ثم عرّبتها فصارت عربية بتعريبها إياها. وما يصدق على هذه الألفاظ إنما يصدق على غيرها مما ورد في الأدب الجاهلي خاصة الشعر، فالمتتبع لهذا الأخير يجد فيه العديد من الألفاظ الفارسية المعرّبة والتي يصعب على الباحثين الوصول إلى أصولها مثل كلمة (الدمقس) التي تعني القز الأبيض وما يماثله في النعومة والبياض، وقد وردت في شعر امرئ القيس في البيت الآتي:
فظَلَّ العذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَشَحَمٍ كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ الْمُفَتَّلِ
وكلمة (الهزبذ)- جمع هرابذة وهم خدم النار- التي استخدمها جرير في هذا البيت:
يَمْشِي بِها البقر الموشِّي أكْرُعَهُ مَشْيَ الهَرابِذِ حجُّوا بَيْعَةَ الزُّونِ
ويظهر أن اللغة العربية تأثرت باللغة الفارسية أكثر من تأثرها بغيرها من اللغات، وتجدر الإشارة إلى أن الألفاظ الفارسية التي دخلت قبل الإسلام أكثر عددا وتنوعا من الألفاظ التي دخلت بعده. ومن الألفاظ التي دخلت في بداية الإسلام (الديوان، الدهقان، الجناح، الصنج، السراج، الخندق، السروال، الجورب، الدولاب، السرداب…)، إلا أننا عندما ننظر في أمر اقتراض كل من اللغتين من الأخرى نجد الفرق بيِّنًا جدًا، إذ إن العربية أخذت القليل من الألفاظ الفارسية بالقياس مع ما أخذته منها الفارسية، وذلك راجع لكونها لغة قوية معبّرة، بينما كانت اللغة الفارسية جديدة، كما أن العرب حينما اقترضوا الألفاظ الفارسية أخضعوها لقواعد نحوهم وصرفهم، وحاولوا تبديلها ما أمكن حتى تتناسب مع أصوات لغتهم، بينما نجد الفرس غالبًا ما يبقون على الألفاظ كما هي في صفتها العربية، ثم إن العرب أخذوا فقط ما يحتاجون إليه من المفردات الفارسية، في حين أخذ الفرس من العربية كثيرًا من الألفاظ التي لها مرادفات فارسية، بل إنهم في كثير من الأحيان استعملوا الألفاظ العربية للتظاهر بإجادتها ومعرفتها أو بهدف استعمال المحسنات البديعية، هذا وقد أخذ الفرس عبارات وجمل من اللغة العربية بينما لم تأخذ العربية من الفارسية سوى بعض الألفاظ والمصطلحات دون تعديها للأفعال أو الحروف، وهذا عكس ما حدث بالنسبة للفارسية.
وعلى الرغم من تعلّم الفرس اللغة العربية وإجادتهم لها، فإننا نرى لسانهم العربي الجديد لا يخلو من أثر اللغة الفارسية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى العرب. ومن أهم العيوب التي نتجت عن اختلاط اللغتين اللكنة (أو العجمة)، واللحن وهي أربعة أضرب:
– الضرب الرابع: هو ما يدخل في العربية من قياسات وصيغ دخيلة لا يعرفها العرب.
وقد سادت الألفاظ الفارسية مختلف أمصار العالم العربي، كالبصرة، والكوفة، والشام، واليمن، والحجاز. ونتيجة هذا الانتشار والاختلاط بين اللغتين في صدر الإسلام خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تفسد طبيعة العرب وتعوج ألسنتهم إثر مخالطتهم للأعاجم، فحرم عليهم امتلاك الضياع في الأماكن المفتوحة، وحثهم على إقامة المعسكرات بعيدًا عن مدنهم، وفي المقابل ابتدع العرب مجموعة من الوسائل لحماية لغتهم.
إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، فاللسان العربي لم يسلم من التأثر باللغة الفارسية حتى في أبسط الألفاظ، كذلك الأمر بالنسبة إلى اللغة الفارسية، لأن اللغة بمثابة كائن حي لا يمكن أن تعيش بمعزل عن غيره من بني جنسه ولا بد له أن يؤثر ويتأثر، بالتالي ليست هناك لغة على وجه البسيطة لا تؤثر وتتأثر إلا إذا كانت لغة ميتة لا استعمال لها.
وفيما يلي بعض الألفاظ المتبادلة بين اللغتين كما وردت عند الثعالبي:
– ألفاظ فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة:
(الكف، الساق، الفراش، البزاز، الوزان، الكيال، المساح، البياع، الدلال، الصراف، البقال، الجمال، الفصاذ، الخراط، البيطار، الرائض، الطراز، الخياط، القزاز، الأمير، الخليفة، الوزير، الحاجب، القاضي، صاحب البريد، صاحب الخبر، الوكيل، السقاء، الساقي، الشراب، الدخل، الخرج، الحلال، الحرام، البَركة، البركة، العدة الصواب، الغلط، الخطأ، الوسوسة، الحسد، الكساد، العارية، النصيحة، الفضيحة، الصورة، الطبيعة، العادة، البخور، الغالية، الخلوق، اللخلخة، الحناء، الجبة، الجثة، المقنعة، الدرعة، الإزار ، المضربة، اللحاف، المخدة، الفاختة، القمري، اللقلق، الخط، القلم، المداد، الحبر، الكتاب، الصندوق، الحقة، الربعة، المقدمة، السفط، الخرج، السفرة، اللهو، القمار، الجفاء، الوفاء، الكرسي، القنص، المشجب، الدواة، المرفع، القنينة، الفتيلة، الكلبتان، القفل، الحلقة، المنقلة، المجمرة، المزراق، الحربة، الدبوس، المنجنيق، العرادة، الركاب، العلم، الطبل، اللواء، الغاشية، النصل، القطري، الجل، البرقع، الشكال، العنان، الجنية، الغذاء، الحلواء، القطائف، القلية، الهريسة، العصيدة، المزورة، الفتيت، النقل، النطع، العلم، الطراز، الرداء، الفلك، المشرق، المغرب، الطالع، الشمال، الجنوب، الصبا، الدبور، الأبله، الأحمق، النبيل، اللطيف، الظريف، الجلاد، السياف، العاشق، الجلاب)[16]
– ألفاظ عربية يتعذر وجود فارسية أكثرها:
الزكاة، الحج، المسلم، المؤمن، الكافر، المنافق، الفاسق، الجبث، الخبيث، القرآن، الإقامة، التيمم، المتعة، الطلاق، الظهار، الإيلاء، القبلة، المحراب، المنارة، الحبيث، الطاغوت، إبليس، السجن، الغسلين، الضريع، الزقوم، التسنيم، السليسبيل، هاروت، وماروت، ويأجوج مأجوج، منكر ونكير.
– ألفاظ قائمة في لغة العرب والفرس على لفظ واحد:
التنور، الخمير، الزمان، الدين، الكنز، الدينار، الدرهم.
الكف: معرب كف وهي البقلة الحمقاء[17].
المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة فارسيتها من جه نيك أي أنا ما اجودني[18].
الطرز: علم الثوب معرب تراز[19].
اللخلخة: فارسته لخلخه وهو ضرب من الطيوب مركب من العود والغبر والادن والكافون[20].
الكلبتان: الة من حديد يأخذ بها الحداد المحمي تعريب كليدن[21].
الدبوس: فارسيتها دبوس وهو المقمعة وهو أيضًا اسم حصن موقعه بين بخاري وسمرقند[22].
الصندوق: هي الصندوق[23]
– ألفاظ تفردت بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي:
الكوز، الإبريق، الطست، الخوان، الطبق، القصعة، السكرجة، السمور، السنجاب، القاقم، الفنك، الدلق، الخز، الديباج، التاختج، الراختج، السندس، الياقوت، الفيرزوج، البجاد، البلور، السميذ، الدرمك، الجردق، الجرمازج، الكعك، السكباج، الدوغباج، النارباج، شواء المزيرباج، الإسبيذباج، الدار جيراج، الطباهج، الجرذباج، الروذق، الهلام، الخاميز، الخواذب، البرماورد أو الزماورد، القالوذج، الجوزينج، اللوزينج، النفريج، الرازينج، الجلاب، السكنجبين، الجلنجبين، الميبة، الدارصيني، الفلفل، القرفة، الزنجبيل، الخولنجان، النرجس، البنفسج، النسرين، الخيبري، السوسن، المرزنجوش، الياسمين، الجلنار، المسك، العنبر، الصندل، القرنفل[24].
وقد جرد الجواليقي وأدي شير أيضا مجموعة من الألفاظ المتبادلة بين اللغتين وهذه بعضها:
– بعض الألفاظ العربية في الفارسية:
الكف: معرب كف وهي البقلة الحمقاء.
المنجنيق: آلة ترمي بها الحجارة فارسيتها من جه نيك؛ أي أنا ما اجودني.
الطرز: علم الثوب معرب تراز.
اللخلخة: فارسته لخلخه وهو ضرب من الطيوب مركب من العود والغبر والادن والكافون.
الكلبتان: آلة من حديد يأخذ بها الحداد المحمي تعريب كليدن.
الدبوس: فارسيتها دبوس وهو المقمعة وهو أيضًا اسم حصن موقعه بين بخاري وسمرقند.
الصندوق: هي الصندوق.
– بعض الالفاظ العربية التي يتعذر وجود فارسيتها:
الزكاة – للاقامة – الحج – الغسلين – المسلم – الضريع – المؤمن – الزقوم – الفاسق – المنافق[25]
– بعض الأسماء القائمة بين العرب والفرس على لفظ واحد:
التنور: من الملابس، ما يحيط بالجسم من الخصر إلى القدمين فارسيتها تنوره.
الدين: المعتمد والمذهب، يطلق على ملاك كان موكلًا على محافظة العالم، وعلى اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، الذي كان الفرس يرسلون فيه أولادهم للمدرسة ويزوجون ويتزوجون.
الكنز: فارسي معرب واسمه بالعربية مفتح.
الدينار: فارسي معرب أصله دنار لم تعرف له العرب اسما غير الدينار.
الدرهم: تعريب درم[26]
– بعض الألفاظ الفارسية في العربية:
الكوز: إناء من فخار له عروة وبلبل تعريب كواز أو كوره.
السكرجة: الصحف، تعريب سكره.
الخوان: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل، تعريب خوان واصل معناها الطعام والوليمة.
الخز: نوع من الثياب معربة عن خاز بالفارسية وهو ثوب من كتان منسوج بغاية الإتقان.
الديباج: معرب ديبا وهو الثوب الذي سداه حرير وقبل مركب من الفارسية ديو أي جن وباف أي نسيج.
الياقوت: ج يواقيت وقد تكلمت به العرب، قال الملك بن نويرة:
لَنْ يُذْهِبَ اللُّؤْمَ تاجٌ قد حجيتَ به من الزَّبرْجَدِ والياقوت والذهب
الفيروزج: حجر كريم وهو المعروف بالفيروز تعريب بيروز.
الدرمك: دقيق الحواري تعريب كرمه الذي بمعناه.
الكعك: تعريب كاك وهو خبز يعمل مستديرًا من الدقيق والحليب والسكر.
السميذ: بالدال والذال، ولذال أفصح: لباب الدقيق.
السيكباج: دواء.
الطباهج: في اللسان الطباهجة فارسي معرب، ضرب من قلي اللحم.
الفالوذج: قال الجواهري: الفالوذ معربان: قال يعقوب ولا يقال الفالوذج وهو من الحلواء، يسوى من لب الحنطة.
الجوزينج: من الحلاوات يعمل من الجوز تعريبه كوزينه.
اللوزينج: من الحلاوات شبه القطائف يؤدم بذهن اللوز تعريب لوزينه.
الجلاب: العسل والسكر عقد بوزنه أو أكثر من ماء الورد مركب من كل أي ورد ومن آب ماء.
السكنجبين: شراب مركب من سك واجبين؛ أي خل وعسل ويراد به كل حامض وحلو.
الجلنجبين: معجون يعمل من الورد والعسل مركب من كل وانكبين أي عسل.
الفلفل: حب هندي شديد الحرافة يطيب به الطعام تعريب يليل.
الكراويا: نبات قريب إلى الأنيسون.
الخولنجان: نبات رومي وهندي يرتفع نحو دراع، أوراقه كأوراق القرفة وزهره ذهبي فارسيته خولنجان أو خالولنجان، ويقال لخشبه بالفارسية خسرودان.
النرجس: نبات من الرياحين تشبه به الأعين معرب نركس.
الجلنار: زهر الرمان مركب من كل؛ أي ورد أي رمان.
النسرين: ورد أبيض عطري قوي الرائحة فارسيته نسرين.[27]
الصندل: شجر هندي طيب الرائحة تعريب جندال.
الكافور: شجر بجبال بحر الهند والصين خشبة أبيض فارسيته كافور ودواء معروف.
المسك: الطيب، فارسي معرب.[28]
وإجمالًا، نستنتج من خلال ما سبق أن ما أخذته الفارسية عن العربية أكثر بكثير من الذي أخذته العربية منها، كما أن العرب تصرفوا في كثير من هذه الكلمات خصوصًا بالتغيير الصوتي، أي أن المعرب الفارسي في العربية أكثر من الدخيل الفارسي فيها[29]. كما أن أغلب الألفاظ المعربة مذكورة في القرآن الكريم مثل كلمة (إستبرق) التي وردت غير مرة فيه، يقول عز وجل: ﴿عليهم ثياب خضر وإستبرق﴾ [الإنسان الآية21]
وقد أورد عبد الجواد إبراهيم نصًا في كتابة “الاقتراض المعجمي” يقول فيه:
“من خلال هذا البحث المتواضع يقوى لدي الباعث على مواجهة الألفاظ الدخيلة في العصر الحديث، بما فعله القدماء من محاولة تطويرهم لهذه الأوزان إلى العربية حتى تمرن عليها الألسنة، وتعتاد عليها وتصير مع مرور الوقت عربية[30].
خلاصة القول، إن العربية والفارسية لغتان تشتركان في كثير من المفردات التي أخذتها كل واحدة منها عن الأخرى، إلا أن تلك التي أخذتها الفارسية من العربية غالبًا ما تركتها على صورتها الأصلية بخلاف العربية التي عربت بعض الكلمات الفارسية.
*كاتبة مغربية
التعليقات